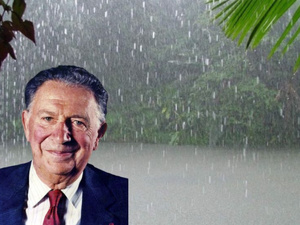بقلم : عدنان بنشقرون
الأمطار لا تمحو الذاكرة المناخية
كل موجة أمطار تعمل كفترة استراحة قصيرة للساكنة تمنح شعورًا بالراحة وتثير الحديث عن “نهاية الجفاف”. هذا الشعور ليس خيالياً؛ في بلد يعتمد كثيرًا على الزراعة، الماء يعادل الحياة والاستقرار الاجتماعي. المغرب لا يخرج عن هذا المنطق العاطفي. لكن المناخ لا ينسى سريعًا، فهو يتحرك وفق دورات طويلة وانكسارات بطيئة وتغيرات تدريجية.
الحوكمة في زمن المناخ لا تقتصر على التعليق على الطقس، بل تتطلب قراءة الاتجاهات طويلة المدى، وفهم ما هو استثنائي وما هو هيكلي، وعدم الخلط بين لحظة استراحة وحل دائم. هذا بالضبط ما أشارت إليه دراسة صدرت في منتصف التسعينيات، بقيت هادئة آنذاك لكنها تحمل رؤية مستقبلية دقيقة، أعدها روبرت أمبروغي تحت إشراف أكاديمية المملكة المغربية، وتعتبر اليوم مرجعًا أساسيًا.
سجلات أرز الأطلس المتوسط كأرشيف مستقبلي
لاحظ أمبروغي أن البيانات المناخية الحديثة للمغرب قصيرة جدًا لتفسير المناخ الحقيقي للأرض. قرن من الملاحظات الحديثة لا يكفي لفهم أرض لها آلاف السنين من التاريخ. لذلك اتجه إلى مصادر أعمق، فاختار أرز الأطلس المتوسط القديم، أشجار عاشرتها قرون وتحمل في حلقاتها سجلات دقيقة للمناخ: حلقات عريضة في سنوات الأمطار الغزيرة وضيقة في سنوات الجفاف. باستخدام علم الأشجار والتحليل النظيري، تمكن من إعادة بناء ألف عام من التاريخ المناخي المغربي.
النتيجة المذهلة كانت أن الجفاف في المغرب ليس حدثًا عابرًا أو استثنائيًا، بل نمط متكرر يشبه "تنفس الأرض المتقطع". وأضاف أمبروغي عنصرًا غالبًا ما كان يُغفل: تأثير الدورات الشمسية على فترات الجفاف الممتدة. الاستنتاج واضح وواقعي: ندرة المياه في المغرب ظاهرة بنيوية تعود دائمًا وتكرر نفسها.
2023–2024: العلم يسبق الواقع
المثير للانتباه هو التنبؤ بالمستقبل. أمبروغي لم يكتفِ بإعادة قراءة الماضي، بل وضع علامات واضحة على السنوات 2023–2024، مشيرًا إلى احتمال حدوث جفاف شديد. واليوم، بعد ثلاثين عامًا، نجد أن المغرب شهد واحدة من أقسى ضغوط المياه في تاريخه الحديث تمامًا كما توقعت الدراسة: مخزونات منخفضة، توترات إقليمية، صعوبات في الموازنة بين الزراعة والمياه الصالحة للشرب والصناعة، هذه المطابقة بين التنبؤ والواقع ليست صدفة، بل دليل على أن الاستماع للعلم يمكن أن يوجّه السياسات العامة، وأن تجاهله يؤدي إلى أزمات.
التغير المناخي : العامل الذي يضاعف الأثر
صحيح أن الجفاف جزء طبيعي من المناخ في شمال إفريقيا، كما أشار عالم المناخ بيير بانيه. الأمطار تعود دائمًا. لكن هذه النظرة وحدها غير كافية، إذ يغفل العنصر الأهم في القرن الحادي والعشرين: الاحتباس الحراري الناتج عن النشاط البشري، الذي يضاعف تأثير الجفاف اليوم، من ارتفاع متوسط درجات الحرارة، وتسريع تبخر المياه، إلى تراجع قدرة التربة على الاحتفاظ بالرطوبة وفترات جفاف أطول وأكثر حدة. الجفاف لم يعد مجرد دورة طبيعية، بل أصبح أزمة هيكلية، أكثر قسوة وكلفة اجتماعية.
حوكمة المياه : التحدي الحقيقي
المسألة الأساسية لم تعد مناخية فقط، بل سياسية واستراتيجية. إذا كانت هذه البيانات متوفرة منذ 1995، لماذا تعاملت الدولة مع المياه غالبًا في وضعية طوارئ بدلاً من التنبؤ؟ لا يمكن إنكار جهود المغرب: بناء السدود، الربط بين الشبكات، تحلية المياه، إعادة استخدام المياه العادمة، برامج ترشيد الاستهلاك… هذه المشاريع موجودة وتحرز تقدماً، ويجب الاعتراف بها.
لكن المشكلة الجوهرية تبقى: الانتقال من دولة متفاعلة إلى دولة استباقية لم يكتمل بعد، كثيرًا ما تسبق الأزمة القرار، وكثيرًا ما تتحكم الطوارئ في جدول الأعمال. في زمن المناخ، الحوكمة لا تعني انتظار المطر، بل التخطيط لغيابه: تكييف الزراعة مع الموارد المائية، تمويل البحث العلمي كاستثمار استراتيجي، وجعل الماء ركيزة من ركائز السيادة الوطنية إلى جانب الطاقة والغذاء.
فرصة تاريخية وليست وهماً مؤقتاً
الأمطار الأخيرة هبة طبيعية تعطي فرصة للتنفس، تهدئ الضغوط على السدود، وتمنح المسؤولين مجالًا للتحرك. لكنها لا يجب أن تغطي على الوضوح الذهني. أرز الأطلس المتوسط لا ينسى، ويذكر دائمًا : الجفاف سيعود. القضية ليست أخلاقية أو جوية، بل استراتيجية. اليوم، يمتلك المغرب عناصر قوة حقيقية : استقرار مؤسسي، رؤية ملكية طويلة الأمد، خبرات علمية محلية، وقدرة استثمارية كبيرة، قلما توجد دول في المنطقة تجمع هذه العوامل. الحكمة الجديدة: الأمطار ستمر، لكن المسؤولية تبقى، والحوكمة الآن تعني التنبؤ بالغياب، واستخدام هذه القيود كفرصة للابتكار، وتعزيز التضامن الإقليمي، وتحقيق التنمية المستدامة
 الرئيسية
الرئيسية